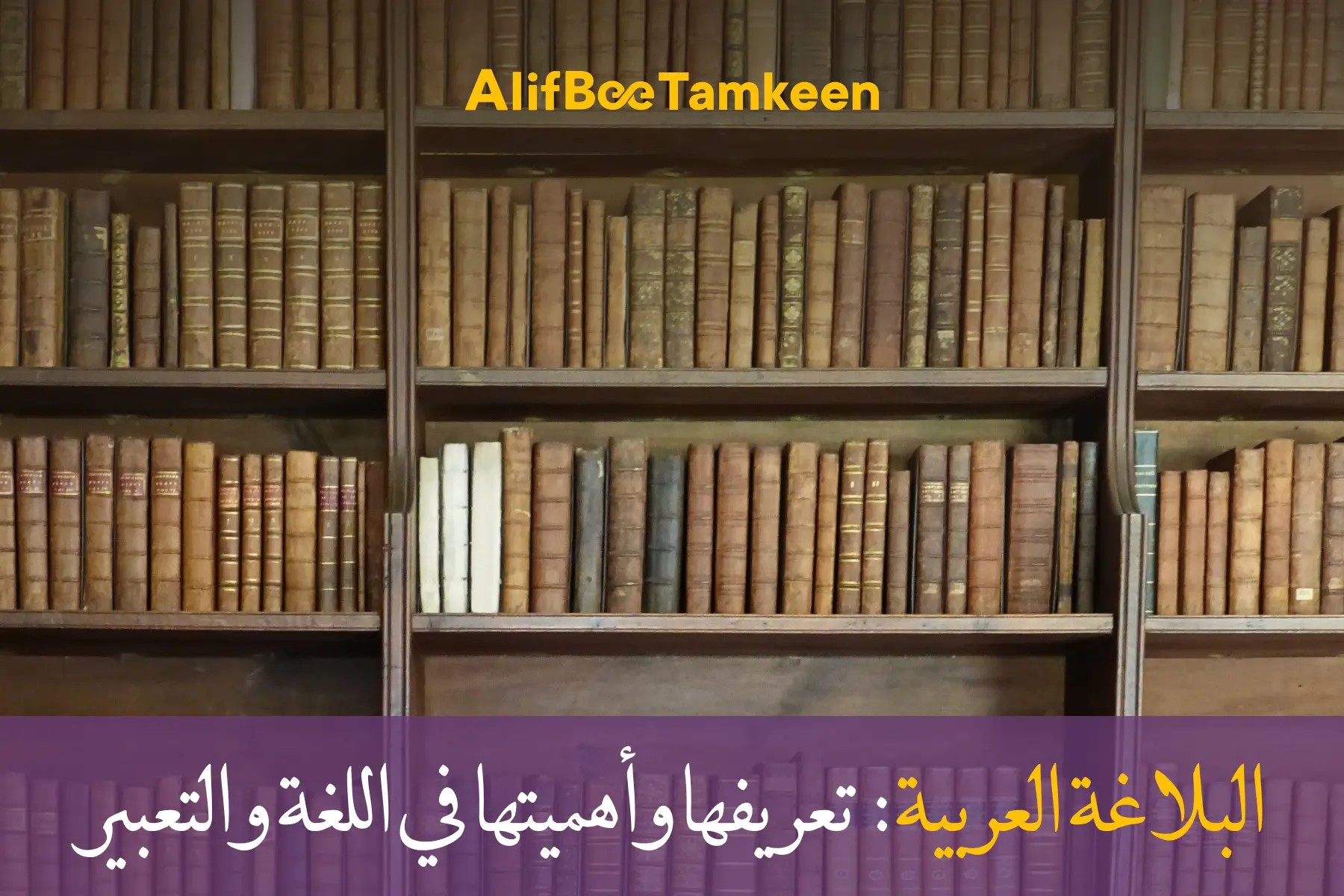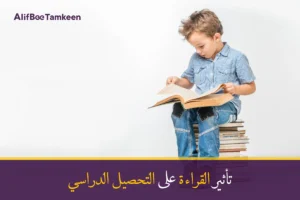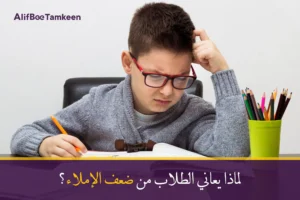ما هو مكان البلاغة بين علوم العربية؟
في عالم اللغة العربية الذي يزخر بالجمال والدقَّة في القاعدة، يبرز علم البلاغة العربية الذي يشكِّل قلب التعبير الفنيِّ والبلاغي، ويربط اللفظ والمعنى، ويهتمُّ بجمالية الأسلوب وسلاسته، وهو ليس مجرَّد علم نظريّ وله قواعد بل هو مفتاح فعلي لتمكين الكاتب والمتحدث من إيصال الفكرة بأسلوبٍ واضحٍ وراقٍ.
وسنتعرَّف في هذا المقال على أهمية علم البلاغة، ومن هو مؤسس هذا العلم، وما هي علومها، وسندرج لكم بعض الأمثلة من القرآن الكريم والشعر العربي الفصيح.
تعريف علم البلاغة العربية
علم البلاغة العربية في اللغة من الفعل بلغ ومعناه وصل، ويُقال: بلغتَ الغاية أي وصلتَ إليها، لذلك تُسمَّى البلاغة فهي تنهي المعنى إلى قلب السامع، أما المعنى في الاصطلاح فقد عرَّفه القزويني: “ “مُطابقة الكلام لمُقتضى حال السّامعين مع فصاحته”، وهو العلم الذي تُعرف به فصاحة الكلام مع مناسبته للمقام، ووفائه بالمعنى المراد مع جمال الأسلوب، ومن الملحوظ أنَّ العلماء قد يقدِّمون تعريفات متنوعة ومتعددة لهذا العلم، ولكنَّ الثابت أنَّ البلاغة ترسّخت كمجالٍ مستقلٍ بين علوم اللغة والأدب.
ما هي أهمية علم البلاغة العربية؟
هناك أهمية كبيرة لعلم البلاغة العربية، وتتجسد في محاور عدَّة أساسية، سنذكرها لكم فيما يأتي:
- تعزيز الوضوح والفصاحة: حيث يساعد علم البلاغة الكاتب أو المتحدث على اختيار الكلام الذي يناسب مقتضى الحال مع الفصاحة، فالبلاغة تعطي أسلوب الكاتب وضوحًا وتأثيرًا، وتجنبه الركاكة.
- تقديم المعنى بالصورة الأجمل: بالبلاغة تُعنى بإيصال المعنى في أحسن صورة، وهذا ما يجعلها من أهم الأدوات التي تخلق أثرًا في المتلقي أو القارئ.
- معرفة المستحسن من القول: فهو يعلِّم الكاتب متى يستخدم التشبيه أو المجاز أو الكناية، ومتى يستخدم الأسلوب الصريح، وهذا ما يمكنه من تجنب الأخطاء في الأسلوب أو اللغة التي تضعف البيان.
- إدراك إعجاز النصوص الدينية والأدبية: فالبلاغة هي بوابة فهم عمق النصوص، ولا سيما نصوص القرآن الكريم التي تزخر بالجماليات اللغوية.
من هو مؤسس علم البلاغة؟
مؤسس علم البلاغة العربية بحسب أغلب الأقوال هو عبد القاهر الجرجاني 400–471 هـ / 1009–1078م وهو أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجُرْجاني، ويعدُّ من علماء العربية البارزين، وهو أحد مؤسّسي علم البلاغة العربية، ولد في مدينة جرجان، ونشأ فيها في أسرة بسيطة الحال، ولم يتسنَّ له السفر طلباً للعلم، لكنّه تلقى العلوم في بيئته المحلية على كبار النحاة والأدباء.
وقد درس الجرجاني النحو والبلاغة، وتأثر بشكلٍ كبيرٍ بمدرستي البصرة والكوفة النحوية، وقرأ على أيدي علماء مثل أبي الحسين محمد الفارسي وأبي الحسن علي بن عبد العزيز الجُرْجاني، ومن أعماله المعروفة كتاب دلائل الإعجاز وكتاب أسرار البلاغة اللذان يُعدّان من أشهر مؤلفات البلاغة، حيث صوَّر فيهما منهجه في دراسة اللغة والنّظم والعلاقة بين اللفظ والمعنى.
علوم البلاغة العربية
لعلم البلاغة أقسامٌ وفروع وفنون، وهي التي تتحكّم في كيفية تناول الكلام من حيث المعنى، ومن حيث الأسلوب وهي ثلاثة سنذكرها فيما يأتي:
علم المعاني
وهو واحدٌ من أقسام البلاغة العربية، ويُعنى هذا الفرع بكيفية إيصال المعنى في الكلام وفق مقتضى الحال، أي دراسة ما ينبغي أن يُقال وكيف يُقال، وفيما يأتي الأساليب الثلاثة التي يشملها لهذا العلم:
- الإيجاز: وهو من أكثر الأساليب عند العرب، وله قسمان هما إيجاز القصر وهو إيجاز المعنى بتقليل الألفاظ والإكثار من المعاني، وإيجاز الحذف وهو الإيجاز الذي يتم فيه حذف كلمة أو جملة أو أكثر.
- الإطناب: وهو تجاوز على القدر الذي يحتاجه الكلام من دون الوقوف عند المقصد، وأنواع الإطناب هي الإيضاح بعد الإبهام، وذكر الخاص بعد العام، وذكر العام بعد الخاص، والاحتراس والتذييل والاعتراض.
- المساواة: وتعني إيراد الألفاظ والمعاني على قدرٍ متساوٍ حتى لا يطغى أحدهما على الآخر.
علم البيان
وهو من علوم البلاغة التي تتعلق بالطرق المختلفة من أجل عرض المعنى الواحد بأوجهٍ مختلفة مع إيراد الدلالة عليه، وله أركان أربعة وهي كالآتي:
- التشبيه: ويمثل إيجاد شيء مشتركٍ بين أمرين، ويحتوي على مشبه ومشبه به مع أداة تشبيه ويربط بينهم وجه الشبه، والذي يعدُّ معيار التشابه.
- المجاز: ويمثل المجاز استخدام اللفظ في غير موضعه وذلك لتواجد ما يمنع إيراد المعنى الحقيقي له، وله نوعان المجاز العقلي والمجاز اللغوي.
- الكناية: ويقصد بها إيراد المعنى بالتلميح عوضًا عن التصريح، ولها أقسامٌ ثلاثة وهي الكناية عن صفة والكناية عن موصوف والكناية عن النسبة.
- الاستعارة: وهي تسمية الشيء باسم غيره إذا قام مقامه، ولها أنواع كثيرة منها الاستعارة المكنية والاستعارة التصريحية.
علم البديع
ويُعنى بتحسين الكلام من ناحية الزينة اللفظية والمعنوية، وله قسمان:
- المحسنات البديعية المعنوية: وهي المحسنات التي تهتم بتحسين المعنى وتجميله وأشهرها الطباق والمقابلة والطي والنشر والتورية وحسن التعليل وحسن التقسيم وبراعة الاستهلال والمبالغة والتوجيه.
- المحسنات البديعية اللفظية: وهي المحسنات التي تهتم بتحسين اللفظ بشكلٍ أساسيٍّ ومن أشهرها الجناس والسجع ورد العجز على الصدر وإيغال الاحتياط والتوشيح وتآلف الألفاظ.
البلاغة في القرآن الكريم والحديث الشريف والشعر العربي
إذا أردنا أن نذكر أمثلة عن أنواع علوم البلاغة من القرآن الكريم أو الأحاديث الشريفة أو الشعر العربي فهي كثيرة جدًا ولا حصر لها، لذلك سنذكر بعض الأمثلة فيما يأتي:
أمثلة من القرآن الكريم
- قال تعالى: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ}، مثال على إيجاز الحذف.
- قال تعالى: {مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّـهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّـهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّـهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ}، مثال على التشبيه التمثيلي.
- قال تعالى: {كِتابٌ أَنزَلناهُ إِلَيكَ لِتُخرِجَ النّاسَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النّورِ}، مثال على الاستعارة التصريحية.
- قال تعالى: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ*إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ}، مثال على الجناس.
- قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ}، مثال على التوشيح.
- قال تعالى: {وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ}، مثال على الإطناب.
أمثلة من الحديث الشريف
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سورةٌ تشفعُ لقائلِها، وهي ثلاثونَ آيةً ألا وهي تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ)، مثال على الإيضاح بعد الإبهام.
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الدين النصيحة) مثال على إيجاز القصر.
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده) مثال على المقابلة.
أمثلة من الشعر العربي
- قال الشاعر: أنَا الذي نَظَرَ الأعْمَى إلى أدَبي وَأسْمَعَتْ كَلِماتي مَنْ بهِ صَمَمُ.
مثال على الكناية عن نسبة. - قال الشاعر: قصرٌ عليه تحيةٌ وسلامُ خلعت عليه جمالَها الأيامُ
مثال على براعة الاستهلال. - قال الشاعر: فَقَبّلتُ رَأساً لم يكن رأس سَيِّدٍ وَكفّاً ككفّ الضّبِّ أو هي أحقَرُ
مثال على التشبيه.
علم البلاغة في تطبيق تمكين
لم تعد دراسة البلاغة العربية حكرًا على الكتب التقليدية، بل توجد اليوم أدوات وتطبيقات تسهّل تعلمها من بينها تطبيق “تمكين العربية من ألف بي” الموجَّه لتعليم العربية بما فيه من دروس منظمة للبلاغة تسهِّل الفهم، ومن أمثلة تفاعلية وتحليل للنصوص، حيث يمكن للمتعلم أن يرى نصوصًا قرآنية وشعرية ونثرية، ويحلّل فيها وسائل البلاغة التي تمّ استخدامها، ويحتوي على تمارين تطبيقية من أجل تطبيق ما تعلمه المستخدم، ويتابع تطوره ومدى تحسنه.
ختاما
إنّ البلاغة العربية ليست علمًا ثانويًا يُمكن تجاهله، بل هي من أهم محاور التمكن من اللغة العربية، فبها يُصبح للكلام شأن وتأثير وليس مجرد نقلٍ للمعلومة، لذلك لا بدَّ من معرفة تعريف البلاغة وفهم أهميتها والتعرّف على علومها، والإلمام بمن أسّسها، ورؤية حضورها في القرآن الكريم والشعر العربي، فهي عوامل تُعزّز من قدرات المتعلم أو المتكلّم، وتجعله أكثر قدرة على التعبير والتأثير.